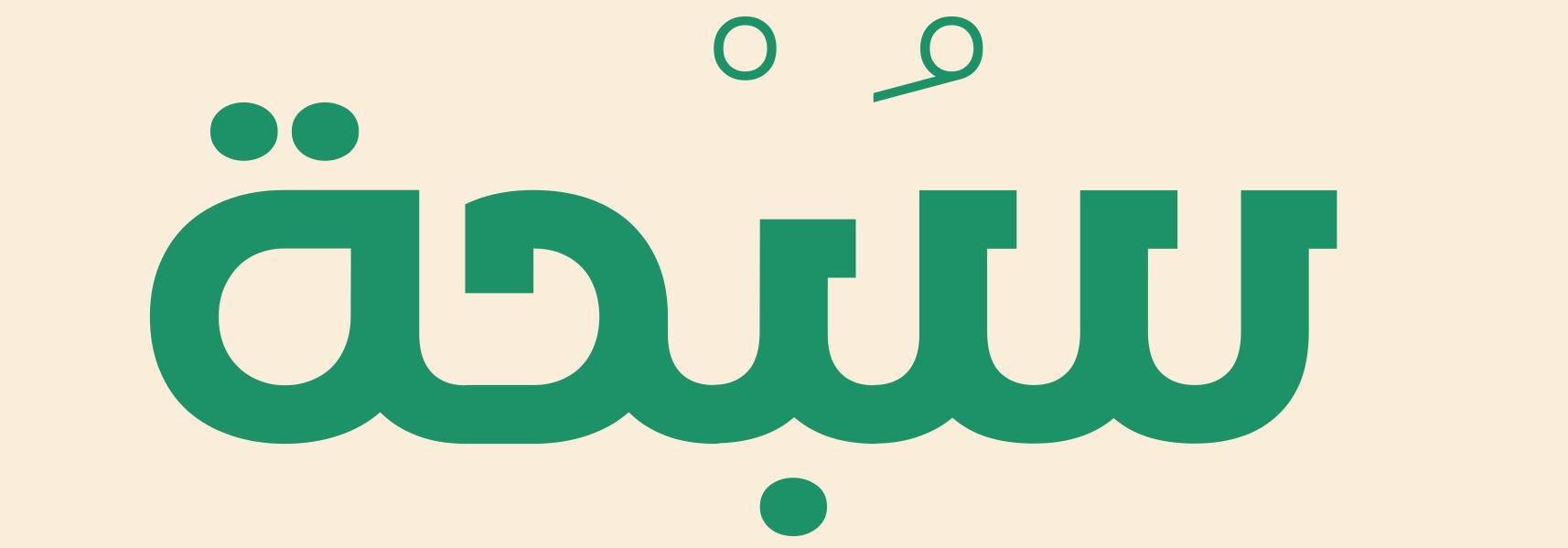يعود الممثل الفرنسي بيار نيني، في السادسة والثلاثين من عمره، إلى شاشة السينما بفيلم «غورو»، بعد النجاح الجماهيري الكاسح لفيلم «كونت مونت كريستو» الذي استقطب ملايين المشاهدين وأعاد تكريسه كأحد أبرز وجوه السينما الفرنسية المعاصرة. في هذا العمل الجديد، الذي يجمعه مرة أخرى بالمخرج يان غوزلان، يجسّد نيني شخصية مدرِّب في التنمية الذاتية يتحوّل تدريجياً من متحدث ملهم إلى «غورو» يمارس نفوذاً نفسياً خطيراً على أتباعه، في رحلة تجمع بين الإغواء، الطموح، والانجراف نحو التلاعب بالعقول.
يشرح نيني في الحوار الذي خصّ به الصحيفة أن رغبته كانت في تقمّص شخصية «الخطيب الكبير»، ذلك النموذج الذي يملك قوة الكلمة القادرة على الارتقاء بالناس أو إسقاطهم في هاوية التبعية. انجذابه إلى عالم الكوتشينغ جاء من ملاحظته للازدهار الهائل لهذا المجال في السنوات الأخيرة، خاصة عبر الشبكات الاجتماعية التي حوّلته إلى فضاء شبه ديني جديد يعد بالخلاص الفردي وبوصفات جاهزة للنجاح والسعادة. من هنا صاغ رفقة غوزلان ملامح مدرّب كاريزمي يمتلك خطاباً ساحراً، لكنه يحمل في طياته سمّ الهيمنة والإخضاع.
الشخصية التي يؤديها، ماتيو فاسور، لا تبدأ من موقع الشر الصريح؛ بل يؤمن في البداية بصدق بما يقدمه لمريديه، ويستند إلى قاموس من «العلوم العصبية» و«النية الطيبة» و«تحرير القدرات». غير أن ضغوطاً عائلية وقانونية ومهنية تدفعه إلى الانزلاق شيئاً فشيئاً نحو استغلال نفوذه الرمزي، فيغدو خطابه أكثر عنفاً وغروراً، وتتحوّل القاعات التي يحاضر فيها إلى مسارح لطاقة جماعية أقرب إلى الطقوس، حيث يختلط التنويم بالإقناع والعلاج بالاستتباع.
الموضوع المركزي للفيلم هو السلطة: كيف تُبنى، وكيف تُمارس، وكيف تُشرعن عبر الكلمة والصورة والسيناريو الشخصي الذي يبيعه «الغورو» لجماهيره. نيني يربط ذلك بما يعيشه العالم اليوم من صعود لشخصيات سياسية شعبوية تكتفي بعدد محدود من المفردات لتأجيج العواطف وتحريك الجماهير، في ظاهرة يراها أقرب إلى خطاب رجعي بسيط منه إلى مشروع فكري معقّد. في هذا السياق يستحضر اسم دونالد ترامب كنموذج للمتحدث القادر على تعبئة ملايين الناس بخطاب يقوم على الصدمة والتكرار، ملاحظاً أن شخصية ماتيو فاسور، على عكس ترامب، أكثر «غنائية» وتزييناً للخطاب، لكنها تشترك معه في استثمار هشاشة الجمهور ورغبته في الإيمان بقائد ما.
تجربة نيني في الكوميدي فرانسيز، حيث لعب أعمالاً لفيدو وموليير وراسين، شكّلت مخزوناً أساسياً لصناعة هذه الشخصية؛ فالمشاهد الطويلة التي يصعد فيها إلى المنصة تشبه في بنائها المسرحي خطباً أو مونولوجات تُدار كأنها مباريات ملاكمة نفسية: جولات متصاعدة، ذروة، ثم انفجار عاطفي. الممثل يتحدث عن «لذة» حقيقية في أداء هذه المقاطع التي تستدعي حضوراً جسدياً وصوتياً مكثفاً، وتتيح له استعادة علاقته القديمة بالمسرح واستثمارها في سينما الإيحاء والإيقاع الداخلي.
على المستوى الشخصي، يعترف نيني بأن التحضير للدور كان جسدياً أيضاً، إذ تبنى بعض طقوس شخصيته مثل الاستحمام بالمياه الباردة وتمارين التركيز، وكأن حدود التمثيل والحياة اليومية تداخلت لفترة. لكنه يحرص على التأكيد أن المسافة الأخلاقية بينه وبين «الكوتش» الذي يجسده تبقى واضحة: الممثل، في نظره، يقدّم للجمهور حكايات وأحلاماً معلنة بوصفها تخييلاً، أما المدربون الروحيون والذاتيّون فيقدّمون خطابهم بوصفه حقيقة مطلقة، وهنا يكمن جوهر الخطر.
العلاقة بين نيني وغوزلان، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون، تشكّل ركيزة أساسية لهذا المشروع؛ فهما يتقاسمان مرجعية سينمائية مشتركة تتراوح بين هيتشكوك وديفيد فينشر، واستلهما في بلورة «غورو» أعمالاً مثل «ماغنوليا» و«ذ وولف أوف وول ستريت» و«ذير ويل بي بلاد»، حيث يجتمع البعد النفسي مع نقد الجشع والشهرة والسلطة الروحية. هذه الخلفية جعلت الفيلم أقرب إلى مختبر يستكشف الحدود الدقيقة بين الخطاب التحفيزي والخطاب التسلطي، وبين الإلهام والابتزاز العاطفي.
ورغم أن مسار نيني المهني يشترك مع شخصية ماتيو في الوقوف أمام جمهور والسعي إلى شد انتباهه، فإنه يرفض أن يُختزل في صورة «غورو» فني جديد. شهرة الممثل وتصاعد شعبيته، وما يُسمى أحياناً بـ«نينيمانيا»، يحاول التعامل معها بالعودة إلى نمط حياة هادئ في الريف، بعيداً عن صخب باريس وعن آليات صناعة النجوم التي قد تدفع البعض إلى الانفصال عن الواقع. بالنسبة له، التوازن بين حياة عائلية مستقرة ومشاريع سينمائية مختارة بعناية هو الضمانة الوحيدة لعدم السقوط في فخ الصورة التي يصنعها الآخرون عنه.
في خلفية كل ذلك يظل المسرح حاضراً كحنين مؤجل؛ إذ يعبّر نيني عن رغبته في العودة إلى الخشبة في مشاريع مثل «هاملِت» أو «أوبرا القروش الثلاثة»، أو حتى نص معاصر يشارك في كتابته وأدائه، مؤكداً أنه لا يريد أن يغلق أي باب إبداعي ما دام الشغف هو المحرّك الأساسي لاختياراته. «غورو» يبدو في هذا المسار خطوة جديدة تجمع بين نضج الممثل الفني ووعيه بالأسئلة السياسية والثقافية المتصلة بقوة الكلمة، في زمن يبحث فيه الكثيرون عن منقذ فردي أكثر مما يبحثون عن مشروع جماعي.